السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يراودني كثيراً التساؤلُ عن السبب وراء عدم اعتكافنا في المساجد، وحفظِ القرآن وفهمه، وجعلِ الحياة الدنيا مقتصرةً على العمل الذي يكفي المسلمَ مؤنة السؤال والاحتياج لغيره.
فهل يوجد سببٌ وراء الاجتهاد في العمل الدنيوي، بالرغم من أن الآخرة هي مآبنا ومسكننا الأبدي؟ ولو وُجد سببٌ يرجح العمل بجد واجتهاد في الدنيا، مع عدم ترك أمور الآخرة، فكيف تكون النسبة والتناسب بين الدنيا والآخرة؟ كي لا نعطي جانباً قدراً أكبر من قدره.
وجزاكم الله خيراً.


 الاستشارات
الاستشارات
 اطرح سؤالك
اطرح سؤالك
 مجالات الاستشارة
مجالات الاستشارة
 قائمة المستشارين
قائمة المستشارين

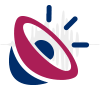
 بحث عن استشارة
بحث عن استشارة الأكثر مشاهدة
الأكثر مشاهدة

 الأعلى تقيماً
الأعلى تقيماً









 الرئيسية
الرئيسية موسوعات
موسوعات مقالات
مقالات الفتوى
الفتوى الصوتيات
الصوتيات المكتبة
المكتبة المواريث
المواريث بنين وبنات
بنين وبنات