السؤال
متى تكون كلمة: الحمد لله، معناها: الكمال لله، ومتى يكون معناها: الشكر لله؟
في الصلاة، عندما نقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد ( أنا أقول في نفسي: ربنا ولك الحمد، يعني ربي لك الكمال، لكن -أحيانا- أظن أن معناها ربنا لك الشكر)، فما هو معناها الصحيح هنا؟ وأيضا في الذكر قول: الحمد لله، ما معناها؟ هل معناها الكمال لله، أم الشكر لله؟
وعند قول ذكر سبحان الله وبحمده. هل معناه أني أنزه الله عن كل نقص، وأثبت له الكمال، أم معناها أنزه الله عن كل نقص، وأشكره؟ وهل الثناء هو المدح؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحمد في لغة العرب ضد الذم، وقد تعددت أقوال العلماء في تحديد معنى الحمد، وإن كانوا متفقين في الجملة على أنه ثناء ومدح، ومن أفضل من تكلم على معنى الحمد، الإمام الطبري، فقد قال في تفسيره: معنى {الحمد لله} الشكر خالصا لله -جل ثناؤه- دون سائر ما يعبد من دونه، ودون كل ما برأ من خلقه، بما أنعم على عباده من النعم التي لا يحصيها العدد، ولا يحيط بعددها غيره أحد، في تصحيح الآلات لطاعته، وتمكين جوارح أجسام المكلفين؛ لأداء فرائضه، مع ما بسط لهم في دنياهم من الرزق، وغذاهم به من نعيم العيش من غير استحقاق منهم لذلك عليه، ومع ما نبههم عليه، ودعاهم إليه من الأسباب المؤدية إلى دوام الخلود في دار المقام في النعيم المقيم، فلربنا الحمد على ذلك كله أولا، وآخرا.... اهـ.
ويرى الطبري، وبعض أهل العلم أن الحمد والشكر معناهما واحد، وذكر ابن كثير في تفسيره أن بينهما عموما وخصوصا، فقال: اشتهر عند كثير من العلماء من المتأخرين أن الحمد هو الثناء بالقول على المحمود بصفاته اللازمة والمتعدية، والشكر لا يكون إلا على المتعدية، ويكون بالجنان، واللسان، والأركان، كما قال الشاعر: أفادتكم النعماء مني ثلاثة: ... يدي، ولساني، والضمير المحجبا، ولكنهم اختلفوا أيهما أعم الحمد، أو الشكر على قولين، والتحقيق أن بينهما عموما وخصوصا، فالحمد أعم من الشكر من حيث ما يقعان عليه؛ لأنه يكون على الصفات اللازمة، والمتعدية، تقول: حمدته؛ لفروسيته، وحمدته؛ لكرمه، وهو أخص؛ لأنه لا يكون، إلا بالقول، والشكر أعم من حيث ما يقعان عليه؛ لأنه يكون بالقول، والفعل، والنية كما تقدم، وهو أخص؛ لأنه لا يكون إلا على الصفات المتعدية، لا يقال: شكرته لفروسيته، وتقول: شكرته على كرمه وإحسانه إلي. هذا حاصل ما حرره بعض المتأخرين، والله أعلم. اهـ.
وأما التسبيح، فالمراد به: تنزيه الله، وبراءته من كل نقص، وذلك يتضمن وصفه بالكمال.
قال ابن عاشور في التحرير والتنوير: التسبيح: الكلام الذي يدل على تنزيه الله -تعالى- عن كل النقائص .... اهـ.
وقال شيخ الإسلام -رحمه الله- في الفتاوى: وقوله: {سبحانك} يتضمن تعظيمه، وتنزيهه عن الظلم، وغيره من النقائص... ونفي السوء، والنقص عنه يستلزم إثبات محاسنه، وكماله، ولله الأسماء الحسنى. وهكذا عامة ما يأتي به القرآن في نفي السوء، والنقص عنه، يتضمن إثبات محاسنه، وكماله، كقوله تعالى: { الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم }. فنفي أخذ السنة، والنوم له، يتضمن كمال حياته، وقيوميته. وقوله: { وما مسنا من لغوب} يتضمن كمال قدرته، ونحو ذلك. فالتسبيح المتضمن تنزيهه عن السوء، ونفي النقص عنه يتضمن تعظيمه. ففي قوله: { سبحانك } تبرئته من الظلم، وإثبات العظمة الموجبة له براءته من الظلم؛ فإن الظالم إنما يظلم لحاجته إلى الظلم، أو لجهله، والله غني عن كل شيء، عليم بكل شيء، وهو غني بنفسه، وكل ما سواه فقير إليه، وهذا كمال العظمة. اهـ.
وأما الثناء، فيأتي بمعنى المدح كثيرا، وقد يطلق الثناء على ذم الشخص بذكر ما فيه من الخصال القبيحة الذميمة، وذهب بعض أهل العلم إلى تخصيصه بالمدح.
قال الفيروزآبادي في (القاموس المحيط): والثناء بالفتح، والتثنية: وصف بمدح، أو ذم، أو خاص بالمدح. اهـ.
ويدل لصحة إطلاق الثناء على المعنيين ما في (الصحيحين)، واللفظ لمسلم عن أنس بن مالك، قال: مُرَّ بِجَنَازَةٍ، فَأُثْنِيَ عَلَيْهَا خَيْرًا، فَقَالَ نَبِيُّ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: وَجَبَتْ، وَجَبَتْ، وَجَبَتْ، وَمُرَّ بِجَنَازَةٍ، فَأُثْنِيَ عَلَيْهَا شَرًّا، فَقَالَ نَبِيُّ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: وَجَبَتْ، وَجَبَتْ، وَجَبَتْ، قَالَ عُمَرُ: فِدًى لَكَ أَبِي، وَأُمِّي، مُرَّ بِجَنَازَةٍ، فَأُثْنِيَ عَلَيْهَا خَيْرٌ، فَقُلْتَ: وَجَبَتْ، وَجَبَتْ، وَجَبَتْ، وَمُرَّ بِجَنَازَةٍ، فَأُثْنِيَ عَلَيْهَا شَرٌّ، فَقُلْتَ: وَجَبَتْ، وَجَبَتْ، وَجَبَتْ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: مَنْ أَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ خَيْرًا، وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ، وَمَنْ أَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ شَرًّا، وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ، أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللهِ فِي الْأَرْضِ، أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللهِ فِي الْأَرْضِ، أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللهِ فِي الْأَرْضِ.
وفي المستدرك على الصحيحين للحاكم عن أبي بكر بن أبي زهير الثقفي، عن أبيه، قال: سمعت النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: يوشك أن تعرفوا أهل الجنة من أهل النار، أو قال: خياركم من شراركم قيل: يا رسول الله، بماذا؟ قال: بالثناء الحسن، والثناء السيئ، أنتم شهداء بعضكم على بعض. والحديث صححه الحاكم، ووافقه الذهبي.
وقال الزبيدي في تاج العروس: وعموم الثناء في الخير والشر، هو الذي جزم به كثيرون؛ واستدلوا بالحديث: مَنْ أَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ خَيْرًا، وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ، وَمَنْ أَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ شَرًّا، وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ .اهـ.
والله أعلم.


 الفتوى
الفتوى
 اطرح سؤالك
اطرح سؤالك
 الفتاوى الحية
الفتاوى الحية
 عرض موضوعي
عرض موضوعي
 فتاوى معاصرة
فتاوى معاصرة
 مختارات الفتاوى
مختارات الفتاوى
 عن
الفتوى
عن
الفتوى 

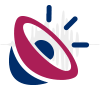
 بحث عن فتوى
بحث عن فتوى العرض الموضوعي
العرض الموضوعي

 الأكثر مشاهدة
الأكثر مشاهدة









 الرئيسية
الرئيسية موسوعات
موسوعات مقالات
مقالات الاستشارات
الاستشارات الصوتيات
الصوتيات المكتبة
المكتبة المواريث
المواريث بنين وبنات
بنين وبنات